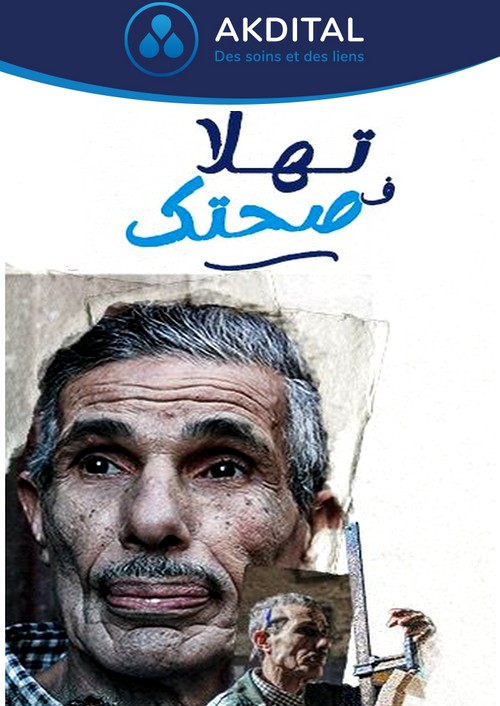كنال تطوان + / الكاتب : صلاح مفيد
بالنظر، من جهة إلى الانقلابات الكبرى التي عرفها الفكر الإنساني منذ “الانقلاب الكوبرنيكي”، ومن جهة ثانية، بالنظر إلى المواثيق والعهود المعلنة من لدن الأمم المتحدة منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي صادق المغرب ـ كما أغلب الدول العربية ـ على جلها، يبدو السؤال أعلاه ونحن في بداية الألفية الثالثة متجاوزا.
إلا أن بعض الوقائع والأحداث، منها على سبيل التمثيل لا الحصر، الدعاوى التي أعقبت تصريحات الأستاذ أحمد عصيد، فتوى المجلس العلمي الأعلى حول حكم المرتد، اعتقال أستاذ بتهمة الترويج للإلحاد، الاعتداء على طالبة جامعية بعد تعبيرها عن رأي في ما يخص العلاقة بين الديني والسياسي… هذا على المستوى المحلي، أما على المستوى الإقليمي، فإن العالم العربي، يعيش منذ اندلاع ثورات الربيع العربي، تكثيفا لصراع مرير بين المحافظين والحداثيين محوره الإنسان.
كل هذا، يدفعنا إلى اعتبار السؤال/العنوان أعلاه، مفتوحا لحد الساعة.
حين ندعو إلى جرجرة أحدهم إلى المقصلة واقعيا أو رمزيا، أو الاعتداء عليه ماديا أو لفظيا، بعد أن عبر بشكل سلمي عن فكرة أو موقف أو تصور حول قضية من القضايا المتعلقة بالشأن العام، على اعتبار الرأي المعبر عنه مستفز لمشاعرنا أو لا يتوافق وقناعاتنا؛ حين لا نقف عند حدود الحق في التعبير السلمي عن رفض هذا الموقف أو ذاك، والتعبير عن رأي مخالف والترافع للدفاع عنه، دون المرور إلى إرهاب خصومنا الفكريين؛ حين ننصب أنفسنا أوصياء على الأفراد ونفرض عليهم خطوطا حمراء للتفكير والسلوك لا يجوز لهم تخطيها؛ حين نخوض حروبا طاحنة تأتي على الأخضر واليابس، بسبب شعارات جوفاء أو أفكار نعتنقها ونعتقد أنها الحقيقة المطلقة التي لا يخالطها الباطل مطلقا.. كل هذا وغيره، يفضح خللا ما في تفكيرنا ورؤيتنا، يدفعنا إلى إعادة التفكير في الأطر المرجعية التي تأطر سلوكنا أفرادا وجماعات.
لن أفصل في المسألة كثيرا، لأنها جد معقدة، وقد تصدى لها العديد من مفكرينا دراسة وتحليلا وتفكيكا، ومن زوايا نظر متعددة تاريخية نفسية واجتماعية.. ووصلوا إلى العديد من الاستنتاجات التي تسعفنا في فهم الظاهرة ومن تم تجاوزها. من جهتي، سأكتفي فقط، بتسليط الضوء على القضية التي تثير اهتمامي، وهي المتعلقة بالشق السياسي، مادام، هو خط التماس بين التيارات الفكرية التي تتنازع المجتمع، مستلها النموذج الخلدوني حول العمران أو ما يصطلح على تسميته ب”الهرم الخلدوني”.
تنطلق كل الحركات السياسية من فكرة تحرير الإنسان من أغلال الاستبداد المسلط عليه من طرف حاكم أو عائلة أو طبقة أو استعمار.. فتنحو إلى التبشير بتصوراتها ومحاولة إقناع المضطهدين بوجاهة فكرتها باستخدام قوة المنطق؛ وكلما كانت قوة الحجة كبيرا، وكاريزما متزعمها قويا، إلا واستطاعت استقطاب أعدادا كبيرة من المريدين والأنصار والمتعاطفين.
من الدعوة، تنتقل الحركة ـ إذا استطاعت، تعبئة أعداد كبيرة من الناس، وهزم السلطات المهيمنة ـ إلى تشكيل الدولة أو السلطة الجديدة، على أنقاض دولة أو سلطة متهالكة. مباشرة بعد ذلك، تبدأ الفكرة الملهمة في التحول إلى أدلوجة، وذلك لتضمن لنفسها الاستمرار لأطول مدة ممكنة، فتتحول شيئا فشيئا من الاعتماد على قوة المنطق إلى منطق القوة، فتسن القوانين من أجل حماية ذاتها، والتضييق على كل المخالفين لها والمناهضين لتسلطها.
هذه باقتضاب شديد دورة صعود وأفول الإيديوجيات، ومعها الحركات السياسية سواء ذات النزعة الدينية أو الوضعية. فمباشرة بعد اعتناقها من طرف مجموعة بشرية، تتحول الفكرة إلى عقيدة، ومن أجل ترسيخ هذه العقيدة في وجدان معتنقيها، يعمد سدنتها إلى إغلاق باب الاجتهاد والتطوير، واعتبارها حقيقة مطلقة في حد ذاتها، فتتحول من خدمة الإنسان إلى اعتباره خادما لها.
هكذا، يصبح الإنسان خادما، لفكرة كانت في الأصل، طوق نجاته من الاستعباد والسخرة.
أما الحل في اعتقادي، فيكمن في استلهام التجربة الغربية، حيث استطاعت دوله الخروج من هذه الحلقة المفرغة، بابتكار آلية سياسية متمثلة في الديمقراطية، تسمح بالتداول السلمي عل السلطة، في ظل استقرار الحكم، وتسمح ـ وهذا هو الأهم ـ بالانتقال من تصور إلى أخر، ومن نخب متمرسة إلى نخب صاعدة، بسلاسة أكبر، على اعتبار أن الأفكار نسبية، دائمة التبدل والتغيير، وبالتالي، هي لا تعدوا أن تكون إلا وسيلة الانسان لما فيه خير الإنسان وسعادته.