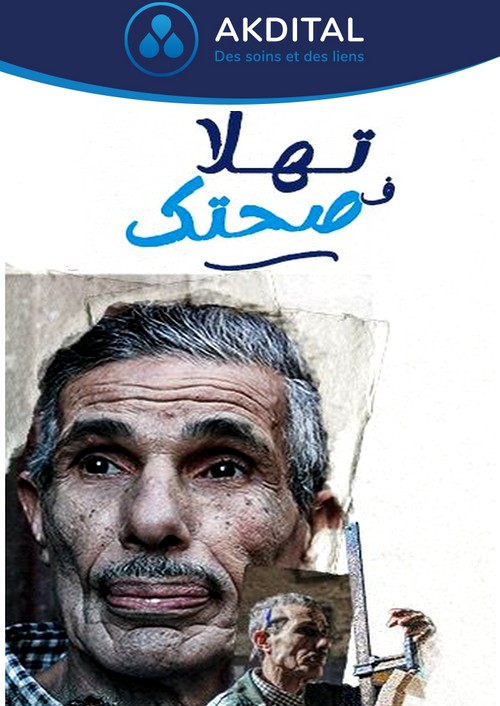كنال تطوان / بقلم : خالد سليكي
في نقده للفكر القومي العربي، يحاول علي حرب أن يبحث عن جواب من خلال عدد من التساؤلات التي تظل قابلة لتفجير تساؤلات أخرى، نحن في أمس الحاجة إليها. يقول:
»»إن وعيي لهويتي كعربي، هو ثمرة الثقافة القومية. ذلك أن كلمة »عرب« كانت تعني في بعض البلدان العربية »البدو« من الأعراب، كما لاحظ ذلك محمد عابدالجابري […] قد يكون مجرد لفظ يأسرنا أو هوام يستبد بنا، وقد يكون بالعكس رمزا للقوة والفاعلية والقدرة على الخلق والابتكار وعلامة على الحضور والازدهار: فأين نحن من اسمنا؟ وماموقعه بين الأسماء؟ أي ما مفاعيله وأصداؤه؟ هل هو يصنع حقيقتنا على نحر خرافي، أم أننا نمنحه وقائعيته وقدرته على الانتشار، بما ننتجه من الوقائع ونصنعه من الحقائق؟ تلك هي علاقتنا الملتبسة باسمنا العربي: إنه مصدر وحدتنا بقدر ما هو مصدر انشقاقنا.« .
ما معنى أن يكون العربي عربيا اليوم؟ وما معنى اللحظة التي يعيشها العربي؟ وهل نحن في حاجة إلى الأنوار كما عاشها الغرب، أم إن الأنوار التي ينبغي تأسيسها يجب أن تصدر من صميم اللحظة والمشاريع العربية التي تجلي خصوصيات الذات العربية؟ ثم ما معنى العقل؟ وهل العقل كما تمظهر في الغرب هو ما يجب أن نؤمن به وبنتائجه؟ أم إنه ينبغي لنا البحث عن عقل مختلف، كما سبق للغرب أن صنع الاختلاف بين الشرق وبين الغرب؟
وما الجدوى من كل ما طرح، ومازال يطرح، في الوطن العربي من برامج و”مشاريع” ما دام أن الإخفاقات هي النتيجة الحتمية، كما أن هذه النتائج هي حصيلة ساهم فيها الجميع مهما اختلفت المرجعيات. إن المآزق التي يتوه فيها الإنسان العربي تعني أن هناك وجها آخر للتخلف والانحطاط الذي يعرف أوج ازدهاره.
بتنا نعيش لحظة الضياع والتيه ولا نعرف ما الذي نريده بالضبط وأين نوجد، لم نتمكن من تحديد موقعنا وجوديا وزمنيا!؟ وهكذا صار العربي يبحث عن حداثة عربية أو حداثة إسلامية. وبينهما كان الانطلاق من العقلانية الأوربية، كما كان البحث عن التطور والتنمية انطلاقا من المفاهيم التي نمت وترعرعت في سياقات ثقافية وفلسفية مختلفة عنا تمام الاختلاف؛ ومن هنا جاءنا الضياع الأخطر.
فما الذي ينبغي القيام به؟ وماهي الاختيارات المعرفية التي وجب سلكها؟
يذهب عبدالله العروي إلى اعتبار أن ما نؤاخذه على الدولة (على أصحاب السلطة)، علينا أن نؤاخذه بنفس القدر على النخبة والمجتمع، لا لنكون منطقيين مع أنفسنا، بل فقط لنكون واقعيين وعلميين. لأنه في العقود الماضية، ظننا أن تحميل المسؤولية لأصحاب السلطة وإرغامهم على تغيير رؤيتهم وسلوكاتهم هو الكفيل بحل المشاكل، واليوم صار واضحا أن ذلك ليس هو المطلب الصائب، وإنه طريق غير سالك؟ ماذا يبقى؟ جواب الأستاذ العروي، كان واضحا ولخصه في التربية، باعتبارها الشيء الوحيد المتبقي. فما المقصود بالتربية، في ظل هذا الواقع التاريخي؟
واضح أن من خصوصيات الفكر العربي المعاصر، احتواؤه على العديد من التناقضات؛ فبين التيارات التي تدعو إلى العقلانية والانخراط في المسار العالمي وما تقتضيه الظروف والسياق العام، ثمة تيار مهيمن لازال يتخبط في الخرافة والأسطورة، ويمجد اللاوعي الزمني ويقدس كل ما هو ماض، بل ليس كل التراث، وإنما جانبا من هذ التراث، وعلى الخصوص الجانب اللاعقلاني بنظرته الأحادية والإطلاقية التي تزداد تفشيا ونموا. والفكر الخرافي الذي يعتمد على البعد الأسطوري قد ينجح في التعبئة وشحذ الأفراد وراء الشعارات التي تعد بالتحرير والتقدم وتحقيق الوحدة واستعادة المجد الضائع، كما أن الأسطورة قد تنجح في تقويض نظام أو إسقاط دولة، ولكنها تظل عاجزة عن الإسهام في بناء مجتمع جديد أو صنع عالم مغاير. ويمكن للأسطورة أن تساهم في التحام العصبيات وَلأم الهويات، لكنها تظل عاجزة على أن تبني مجتمعا مدنيا يقوم على العقد والدستور والشراكة أو على العقلانية والحريات، كما يقول حرب.
ولعل من المفارقات التي يعيشها العقل العربي المعاصر، هو هيمنة الفكرالأسطوري اللاتاريخي، في مقابل نفيه للآخر ولكن مع الاستفادة واستغلال التقنيات والمنتوجات الفكرية والعلمية المستوردة من الغرب.
إذا، أين يكمن الخلل؟ وما الذي يجعل العقل العربي يظل حبيس تصورات لاعقلانية؟ ولماذا انتصر اللاعقل وظلت العقلانية لاتشكل سوى انفلاتات سرعان ما يتم القضاء عليها وتغييبها؟
إن الفكر العربي لم يتمكن بعد من استيعاب مكاسب العقل، من عقلانية وموضوعية وفعالية وإنسية. وهذا التأخير-في نظر العروي- لن يزيد إلا في تعميق الأزمة، لذلك فليس ترديد الدعوة اليوم عنوان الرجوع إلى فترة سابقة، بقدر ما يعني ذلك وعيا خطيرا بالنقص ومحاولة استدراكه بأسرع وقت. وما يؤرق حقا، هو أن الخطاب التراثي، برمته، محروس من قبل ممثلين لنمط يُراد له أن يستمر، وإن أية محاولة للتواصل معه ينبغي أن تتم وفق ما ترغب هذه الجهة التي تحرسه، فمن »أراد أن يحيي البعض من مفكري الماضي فإنه لا محالة مدفوع إلى إحياء الكل، وهذا هو سر موقف المؤسسة التقليدية عندما تصفق لإحياء كل قسم من التراث القديم، مهما كانت الأغراض والظروف. إنها تعلم أن النتيجة العامة ستكون في صالحها« (العرب والفكري التاريخي، ع.العروي).
من كبرى العوائق التي تقف سدا منيعا أمام الفهم الصحيح الذي يمكنه أن ينمي المعرفة ويؤسس لبنيات إنتاج معرفية أيضا، هو غياب الوعي التاريخي الذي تترتب عليه اللازمنية وتتشابك فيه الأوضاع وتضيع الحقائق ويتم إنتاج وتسويق حقائق يراد لها أن تكون هي الحقيقة المستهلكة والمتداولة. فما يعلمنا التاريخ، هو أن زمنية التاريخ غير زمنية الفرد. فالمرء يظن أنه تجاوز إشكالية أو قضية ما، في حين أن مجتمعه مازال يتخبط ويتعثر في تناقضاتها. أي إن العقل العربي كما هو عليه الحال، راهنا، يتنقل بين الفترات التاريخية بصورة متعالية لا يميز بين الحقب، ولايعير أهمية للبعد التاريخي والتطورات والسياقات الثقافية العامة التي كانت تتحرك داخلها قضية أو حركة أو فكرا. وهكذا استمرت النظرة السحرية في كل المقاربات التي تتعاطى للتراث، مع حضور الحس الانتقائي المشبع بخلفيات إيديولوجية تحاول أن تمحو كل المكونات التي من شأنها أن تسقط طابع القداسة والتعالي، وتجعل من الراهن مكونا فاعلا في عملية إعادة إنتاج المعرفة والتواصل المعرفي مع التراث. ذلك أن التراث لا يمكن أن ينظر إليه إلا باعتباره خطابا (نعني المستوى المعرفي العالم)، ومن حيث هو نصوص في حاجة دائمة إلى إعادة اكتشافها وإنتاجها وإشراكها في عملية تشكيل المعرفة الراهنة. وفي ثقافة احتل النص الديني فيها -ولايزال- مركز الدائرة، يعد الكشف عن مفهوم النص، كشفا عن آليات إنتاج المعرفة، بما أن النص الديني صار النص المُوَلِّد لكل -أو لمعظم- أنماط النصوص التي تختزنها الذاكرة/الثقافة. ومعنى ذلك أن الأهم هو البحث عن نمط الثقافة التي تنتمي إليها، ؛مت يرى نصر حامد أبو زيد.
فهل يفهم من هذا أن قضيتنا تكمن في علاقتنا بالتراث؟
إن جزءا كبيرا من معضلة البؤس الذي يتخبط فيه العقل العربي، لايمكن أن يدرك إلا بالبحث في حفرياته المعرفية، وما تسرب خلال تاريخ المعرفة الطويل. فالتاريخ الحقيقي لم يتحقق بعد، لأن العربي لازال يخشاه، ولازال يتعامل مع الماضي بالتقديس أو بالخوف، أي إما أنه يخشاه ويخشى ما قد يجره عليه من حقائق لم يكن مهيأ لاكتشافها أو إنه، أصلا، لا يرى له المصلحة في ذلك فيلجأ إلى أسطرته واعتباره قطعة هناك وهي ليس منه، بقدر ما أنه يمثل جزءا منها! »لذلك فنحن ملزمون بالرجوع إلى ابن خلدون سواء انصرف اهتمامنا إلى الحضارة العربية الإسلامية كدول ومجتمعات واقتصاد أو كان شاغلنا الحضارة العربية كفكر وثقافة. وابن خلدون لايقدم لنا المادة وحسب، بل يقترح نوعا من القراءة لهذه المادة، قراءة واعية بأسسها ومنهجها. ليس المهم أن يكون ابن خلدون قد أصاب في هذه النقطة أو أخطأ في تلك، المهم أنه حاول أن يضع فهمه للحضارة العربية الإسلامية خارج منطقة الصواب والخطإ، أي خارج النظرة المعيارية” فالصواب عنده هو ما كان، والصواب عنده هو أن نفهم ما كان على الشكل الذي به كان«.
إن استحضار ابن خلدون، لايعني العودة المقدسة إلى الماضي، بقدر ما يعني أن الماضي يمكنه أن يشكل مصدرا لعدد من المعاني، وليس الحقائق. فالعودة إلى الماضي، هي عودة من أجل البحث عن المعاني التي سنستثمرها من أجل البحث عن الحقائق التي ينتجها الراهن/الحاضر. ولعل أهم ما يقتضيه ذلك، هو أن يتم إسقاط كل فكر ينزع إلى الطابع الأسطوري وإسقاط كل سمات القداسة، ثم ضرورة إعمال العقل في كل عمليات الإدراك. ويبقى من بين السبل التي ستساعدنا على ذلك، هي تحديد موقعنا وطرح الأسئلة التي تساعد على إيجاد مواطن الخلل، لأن قضيتنا لا تكمن في الجواب الذي قد يتجلى في استيراد آلة أو منهج، وإنما يكمن في نوع الأسئلة التي ستحدد اختياراتنا ومواقعنا الحضارية وموقفنا من الذات أولا في بعدها الراهن، ثم من الآخر في اختلافه وغيريته.
إذا، فالتربية تعني هنا وضع الذات والعقل العربيين في موضع المساءلة، والبحث عن ماهية كل منهما، وعن خصائصهما، مع الوعي بالأبعاد التاريخية، وإعمال العقل ومبادئ العقلانية، لأن العائق المركزي في مسار الحضارة العربية، كان ولازال، هو تغيبب العقل. ومن ثم كانت ضرورته.
هل نحتاج إلى عصر أنوار عربي؟
يمثل عصر الأنوار نقطة تحول عميق على مستوى النظام المعرفي الغربي، كما أنه يشكل نقطة ومرجعية فكر الحداثة. وقد عبر هيجل قائلا: »إن مبدأ العصور الحديثة هو عموما حرية الذاتية«، وهو يعني أن طبيعة العلاقة مع الذات هي المؤسس للحداثة التي تقوم على أربعة مرتكزات أساسية: العقلانية، التاريخانية، الحرية، العلمانية. ويعني هذا أن الحداثة تعتبر الذات مصدر المعرفة، لأن الوعي هو الذي يقوم بتمثل الوجود، ومنه يقوم بإصدار الأحكام حول ما يقع حوله بصورة عقلانية، والتي هي بدورها تطمح إلى تأكيد سيطرة الإنسان على الطبيعة ومن هنا كانت ترى في التقنية رؤية للوجود.
في حين تجد التاريخانية مكانها في فكر الحداثة من جهة معقولية التحول الذي يخضع »للتقدم«. أما الحرية، فتكمن في حق الإنسان في اختيار وتقرير شؤونه المدنية دون أن يخضع في ذلك لإكراهات أو قيود. وتبقى العلمانية إحدى المقولات الهامة، وهي ترتكز على فصل ما هو سياسي عن ما هو ديني، في سعي واضح نحو إسقاط النزعات القدسية عن النصوص المقدسة، مع التركيز على “الإنسان” من حيث هو مفهوم مرجعي للممارسات النظرية والأخلاقية والسياسية والسلوكية.
فهل مقولة الحداثة التي ارتكزت على »العقل« و »الإنسان«، صالحة لتأسيس منعطف في العقل العربي الذي لازال يعيش »صدمة الحداثة« التي لم تزده إلا تراجعا وفقدانا للعقل؟ ثم كيف يمكن تحرير العقل العربي من ظلاميته ومآزقه؟