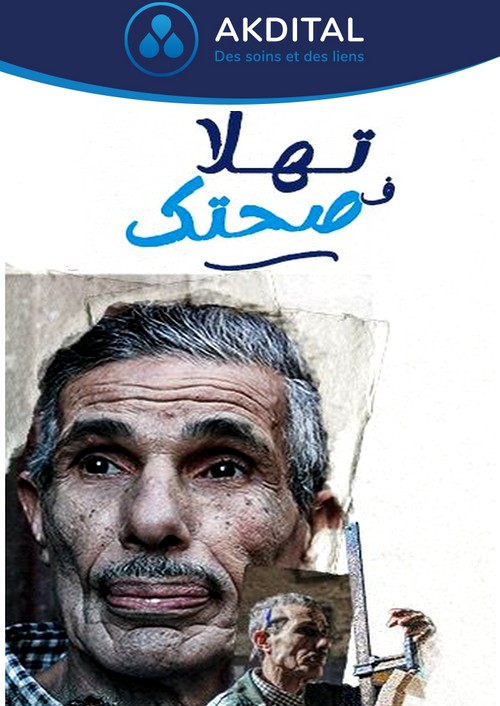الطريق إلى فلسطين تمرُّ عبر تطوان، على الأقل هذه الأيام، والحمامة الأندلسية البيضاء تحتفل باليوبيل الفضي لمهرجانها السينمائي المتوسطي. دُعيت إلى تطوان أكثر من مرة، وكانت ظروفي المهنية وتنقلاتي دائما تجعلني بعيدا عن جبل تطوان وبحر مرتيل زمن المهرجان. لكن هذه المرة تبدو المناسبة سانحة، وكانت فلسطين سبيلي إلى تطوان.
منذ البداية اقترح عليّ الصديقان عبد اللطيف البازي ومخلص الصغير ندوة “السينما الفلسطينية” لأسيِّرَها، لكن ما إن وصلتُ تطوان حتى بُلِّغتُ بأنّه جرى تغيير موقعي في الندوة من مسيّر لها إلى مُتدخّل. هكذا أغلقت عليّ الغرفة في الفندق وبدأت أستدعي ذاكرة الكومبيوتر. في العالم العربي، حينما تكون مشتغلا في حقل الصحافة الثقافية تصير مطالَبًا بالإحاطة بكل مجالات الإبداع الأدبي والفكري والفني، ليس كما هو الحال في الغرب، حيث الصحافة الثقافية مفتوحة على التخصّص والإيغال فيه. لحسن الحظّ، لي بالسينما الفلسطينية، أفلاما وصُنّاعَ أفلام، معرفةٌ لا بأس بها؛ ثم إنّ كومبيوتري المحمول كان معي وذاكرته تفي بالغرض.
لكن مع ذلك، فضلت أن أنطلق من الأرضية التي اقترحها الصديق الناقد السينمائي والأدبي عبد اللطيف البازي لهذه الندوة ـ الأرضية المنشورة في كتاب المهرجان تحت عنوان “السينما الفلسطينية: صور الحنين والمكابرة” – حيث كتب: “منذ البدايات كان قدر السينما الفلسطينية أن تكون سينما ذات أطروحة، فهي رافقت العنفوان الأول للكفاح المسلح وسجلت خطوات الصمود والمكابرة ثم صاحبت تعقيدات هذه القضية ورهاناتها الصعبة.”

التقطت من ورقته مفهوم “الأطروحة” الذي أعتبره إلى جانب “القضية” مفهوما مركزيا في سينما فلسطين، لكنني مع ذلك تحفظت على ربط صديقنا عبد اللطيف للإنتاج السينمائي الفلسطيني بالكفاح الوطني الفلسطيني؛ فتاريخ السينما في فلسطين يعود إلى ما هو أبعد بكثير، بل إنّ السينما الفلسطينية سابقةٌ حتّى على الصراع العربي الإسرائيلي وعلى نكبة 48.
وحين أؤكّد أنّ السينما الفلسطينية سابقة على هذا الصراع فلكي ننصفها جهويا ومتوسطيا؛ فلها جدارة تاريخية تجعل من الطبيعي، حتى خارج منطق التعاطف مع القضية، أن نُفرد لها ندوات وحلقات دراسية في فضائنا المتوسطي؛ ذاك أنّ فلسطين اعتُبِرَت أرضا خصبة للسينما منذ العشرينيات من القرن الماضي. الأخَوان إبراهيم وبدر لاما صوّرا فيلمهما “الهارب” في مدينتهما بيت لحم سنة 1935. إبراهيم حسن سرحان افتتح أستوديو للإنتاج السينمائي في مدينة يافا عام 1936. بل يُعتبر سرحان أول فلسطيني صوّر أفلاما بفلسطين خلال ثلاثينيات القرن الماضي، وذلك قبل الأخَوين لاما. هناك أيضًا محمد صالح الكيالي الذي استفاد من دورات في التصوير والمونتاج في فرنسا وعاد إلى يافا هو الآخر ليفتتح بها أستوديو للتصوير سنة 1939؛ فيما يمكن اعتبار فيلم “حلم ليلة” لابن يافا صلاح الدين بدرخان أول فيلم روائي فلسطيني تم تصويره سنة 1946 وتم عرضه أشهرا قبيل نكبة 48 بكل من فلسطين والأردن. بالنسبة لصالات العرض، غزة عرفت افتتاح قاعة سينمائية “السامر” منذ الأربعينيات، وبالمناسبة هناك مصادر تتحدّث عن توفّر فلسطين على 35 دار للعرض السينمائي في مختلف المدن الفلسطينية قبل النكبة. ثم هناك دينامية موازية على المستوى الصحافي أنجبت عدة منابر شبه متخصّصة في السينما: “الحقيقة المصوّرة” التي صدرت في عكا سنة 1937، “صوت الرأي العام” سنة 1939 بعكا دائما.. مجلة “الأشرطة السينمائية” التي أصدرها بالقدس إبراهيم تلحمي سنة 1937.. “الرياضة والسينما” التي أصدرها جبرائيل شكري ديب بالقدس سنة 1945. أكرّر أنّ كل هذه الدينامية في الإنتاج والعرض السينمائيين وفي المواكبة الصحافية المتخصّصة حصلت قبل النكبة، أي قبل أن يكون هناك أصلا في المنطقة كيانٌ اسمه إسرائيل.
إذن، هذا فقط للتأكيد على أنّ تخصيص ندوة للسينما الفلسطينية هو أمرٌ له ما يسوِّغُه من حيث المشروعية التاريخية على الأقل، مع العلم أن الفلسطينيين لم يكونوا وحدهم في الساحة في تلك المرحلة، مرحلة ما قبل النكبة؛ فالآخرون أيضا كانوا هناك، بل وكانوا أسبق من الفلسطينيين إلى تصوير بلادهم واستثمار هذه الصور لغايات لم تكن فنيّةً دائما.
يجب ألا ننسى أن الأرض الفلسطينية صُوِّرت بأوائل الكاميرات التي صُنعت بالعالم؛ فبعد اختراع الأخوين الفرنسيين لوميير لآلة تصوير الفيلم المتحرك عام 1895، وسنةً واحدةً من إنتاج فيلمهما الأول، أرسلا عام 1896 المصور ألكسندر فروميو إلى القدس لتصوير أول فيلم يعرض مظاهر الحياة في المدينة المقدسة. وجاء هذا الفيلم القصير تحت عنوان “مغادرة القدس عبر قطار”. طبعًا الهدف كان الاستجابة لتوق الجمهور الغربي المسيحي إلى الاطلاع عن قرب على البقاع المسيحية المقدسة بالأراضي الفلسطينية.
الغريب أنّ الحركة الصهيونية التي ستلتئم في مؤتمرها الأول في “بازل” السويسرية سنة بعد صدور هذا الفيلم، وبالضبط سنة 1897، ستطّلع على فيلم الأخَوين لوميير وستتفطّن إلى أهمية فن السينما، فبادرت بدورها إلى استثمار هذا الاختراع الجديد لخدمة هدف المؤتمر، وهو إقامة وطن قومي لليهود. هكذا أقرّ المؤتمر الصهيوني الأول توصية بضرورة بلورة إستراتيجية صهيونية تدعو إلى تطوير اللجان السينمائية مع تطوّر الحركة الصهيونية والدعوة إلى إقامة الوطن القومي لليهود في دولة إسرائيل؛ وهو ما بدأ العمل به فعليا ما بين عامي 1899 و1902، إذ تمّ تصوير أول باقة من أفلام الدعاية الصهيونية عن أرض الميعاد. حدث هذا قبل سرحان والكيالي والأخَوين لاما، في زمن كانت فلسطين مازالت ترزح تحت الاحتلال العثماني الذي كانت قوانينه تحظر من الأصل الصحافة المستقلة على الفلسطينيين حتى عام 1908.

بعد نكبة 48، فقدت فلسطين ليس فقط استوديوهاتها وقاعاتها وأرشيفها السينمائي، بل مدنها وقراها. يجب ألا ننسى أنّ أكثر من 350 قرية فلسطينية دُمِّرت عن آخرها. هكذا تعرّض السينمائيون الفلسطينيون الأوائل للشتات.
طبعًا، لم أكن أريد التورّط خلال الندوة في ورقة تأريخية لمسار صناعة الفيلم الفلسطيني بعد النكبة، مع أنّ الواقع يسعفنا بنماذج لمن يمكن أن نسمّيهم سينمائيّي الشتات، وعلى رأسهم أحد الرواد، إبراهيم حسن سرحان الذي لجأ إلى الأردن، وفيها سيُصوّر فيلم “صراع في جرش” عام 1957، الذي دخل التاريخ بصفته أول فيلم روائي طويل في تاريخ السينما الأردنية. إبراهيم حسن سرحان سيفتح الباب طبعًا أمام مخرجين فلسطينيين آخرين سيصنعون أفلامهم في الأردن دائما. أفكر في “عبد الله كعوش” الذي أخرج وأنتج سنة 1962 فيلمه “وطني حبيبي” الذي يقدَّم هو الآخر ضمن الفيلموغرافيا الأردنية. وهناك من ذهب أبعد من الأردن، كجمال الأصفر، مخرج فيلم “في ليلة العيد”، الذي لجأ مثلا إلى الكويت. وهكذا تفرَّق دمُ سينما الشتات الفلسطيني بين بلدان اللجوء.
في المقابل هناك السينما التي انطلق منها صديقنا عبد اللطيف البازي في أرضيته، سينما فلسطينية خالصة، هي سينما الكفاح الفلسطيني التي بدأت فعليا مع تأسيس وحدة الأفلام لدى منظمة “فتح”، وكانت عمليا أول وحدة سينمائية تابعة لتنظيم مسلح. باقي التنظيمات الفلسطينية حذت حذو فتح وصارت لكل منها وحدة أفلام خاصة بها، قبل أن يتمّ توحيد هذه الخلايا السينمائية الفلسطينية ضمن مؤسسة السينما الفلسطينية التي أشرفت عليها منظمة التحرير، وكان الهدف المركزي المسطّر لها هو إنتاج أفلام توثّق للمعارك العسكرية والسياسية للثورة الفلسطينية، وإنتاج مادة بصرية تروّج لعدالة القضية الفلسطينية في الإعلام العالمي. نقطة التحوّل في عمل هذه المؤسسة كان إنتاجها سنة 1982 لفيلم “عائد إلى حيفا”، الذي اقتبسه عن رواية الشهيد غسان كنفاني المخرج الفلسطيني من أصل عراقي قاسم حَوَل، الذي برمج له المهرجان فيلمه “الهوية الفلسطينية”، والذي صوره قاسم سنة 82، ووثق فيه لغزو الجيش الإسرائيلي للبنان عام 1982 وأنتجه سنة بعد ذلك.
بالنسبة لي، كنت أرى وأنا أفتتح الندوة بأوّل مداخلة أنّ هذه التوطئة التاريخية لبدايات السينما الفلسطينية ومنعطفاتها الأولى كانت ضرورية على الأقل لكي نعرف أن السينما الفلسطينية سابقة عن القضية والنضال والأطروحة على حدٍّ سواء. لكن هذا لا يمنع أن يستدرجنا اليوم كل حديث عن سينما فلسطين في الفضاء المتوسطي إلى طرح سؤال الوجود الفلسطيني والمعاناة مع الاحتلال الإسرائيلي، وإلى استحضار قضية لعلها القضية السياسية والإنسانية الأكثر تعقيدًا في حوض المتوسط.
لذا من الطبيعي أن نتلقّى اليوم الأفلام الفلسطينية من إنتاجات المؤسسة – مؤسسة السينما الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير – حتى الإنتاجات المشتركة لمبدعين فلسطينيّين شباب يحشدون فرص الإنتاج والدعم من الشرق والغرب (من أبو ظبي ودبي والدوحة، حتى باريس وبرلين)، وينجزون أعمالهم انطلاقا من فلسطين التاريخية: القدس وحيفا، أو من أراضي السلطة الفلسطينية: رام الله وغيرها. لكن هذه الإنتاجات كلها لا تخرج في تلقِّينا العربي لها عن إطار “سردية فلسطينية” تطرح نفسها كسردية ردّ وتصحيح – أو فضحٍ وتوضيح – على السردية الإسرائيلية.
لهذا بالضبط، ومع قناعتي التامة بأن ممارسة النضال السياسي المباشر عبر أدوات الفن أمرٌ متجاوزٌ اليوم، إلا أنني واثقٌ في الآن ذاته بأنّ الفنان الفلسطيني محكومٌ بشرط الاحتلال، لا يمكنه أن يكتب ويصنع أفلاما عن الحب والصداقة والغيرة والهجرة والرقص دون أن يجد نفسه بمواجهة هذا الشرط. وأخشى أنّ حصيلة الإنتاج الفلسطيني الذي يحاول غضّ الطرف عن شرط الاحتلال قد تأتي مضحكة، لذا تبقى العبرة بأسلوب المعالجة، وبمدى قدرة المبدع الفلسطيني على الذهاب المرهف الشفيف إلى الجوهر الإنساني لشخوصه ومحكياته الفيلمية.
زرتُ فلسطين بدعوة من وزارة الثقافة الفلسطينية وتحرّكتُ هناك بين رام الله ونابلس وبيت لحم وجنين، وفهمت معنى العيش تحت نير الاحتلال؛ فبسبب الحواجز الإسرائيلية في قلب مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية فهمتُ أنّه من المستحيل أن تكون سائحا عاديا في بلد مثل فلسطين، كما لا يمكنك أن تحب بشكل عادي في فلسطين، ولا أن تمرض بشكل عادي. هناك وضع خاص يفرضه واقع الاحتلال على حياة الناس اليومية، ومن الصعب أن يتجاهل الأديب والفنان هذا الشرط المعقّد، بل التحدّي هو كيف يستثمره انطلاقا من رؤية جمالية خاصة، وهذا ما تحاول السينما الفلسطينية القيام به في الآونة الأخيرة. وبرأيي أن عددا من الأعمال السينمائية توفّقت في ذلك. في فيلم “مفك” لبسام جرباوي الذي شاهدناه مساء الإثنين الماضي بسينما “أبنيدا”، في إطار فعاليات مهرجان تطوان، لم يكن لزياد، بطل الشريط، شغف آخر غير كرة السلة وشرب البيرة مع رفاقه، لكن الشرط الخاص واليوميّ الفلسطينيّ المفخّخ وضعاه أمام منعطف جحيمي: أسيرًا لمدة 15 سنة من أجل “جريمة” لم يرتكبها وبطولة لم يَسْعَ إليها. شرط خاص واستثنائي يمنع المخرج الفلسطيني من أن يفعل مثل نظيره الأمريكي الذي أنتج لنا عددا من أفلام النجاح الرياضي لشباب أمريكيّين كانوا شغوفين بكرة السلة أو البايزبول أو الملاكمة وقادهم شغفهم بهذه الرياضات وتفانيهم فيها لأن يصيروا أبطالًا متَوّجين ونجومًا لوامع. كان بإمكان زياد أن يتحوّل إلى نجم في كرة السلة، لولا أنه فلسطيني. هذا هو الشرط الذي يستدرج المبدع الفلسطيني إلى الأطروحة، إلى قلق الوجود الذي يجعل من كتابة الحياة البسيطة وملاحقة المسرّات والمشاكل الصغيرة عبر الكاميرا كما يفعل باقي مخرجي أرض الله الواسعة ترفًا غيرَ متاحٍ للفلسطيني.
ومع ذلك فالمطلوب اليوم من النقد السينمائي العربي أن يواكب هذه المراوحة الصعبة، والخلّاقة، التي انخرط فيها سينمائيون فلسطينيون جدد ومستقلّون ما بين العام والخاص، الوطني والشخصي، الجمعي والفردي، في أفلام لها شعريتها الخاصة وانفلاتاتُها المفاجئة ومزاجها الصعب، أفلام لها قضاياها الجديدة ومداخلها المتجدّدة. لذلك كان الناقد السينمائي المغربي محمد طروس موفّقا في الندوة وهو يتحدّث عن مركزية الحاجز كمفهوم في السينما الفلسطينية. هذا مدخل يمكننا أن نقارب به عددا من الأفلام الفلسطينية.. الحاجز بكل أنواعه.. ليس فقط الحاجز المادّي المباشر كما صوّرَتْه عدد من الأفلام الفلسطينية من خلال جدار الفصل البغيض، ثم الحاجز في المعابر، في نقاط التفتيش، وفي الأسلاك الشائكة… وإنما كل أنواع الحواجز الرمزية التي تحتال عليها السينما الفلسطينية بالإبداع كما فعلت رندا الشهال مثلا في فيلمها “طيارة من ورق”.
في تطوان، تحضر فلسطين عبر برمجة متنوّعة غنيّة. مؤيد علوان قدّم فيلمه الجميل “التقارير حول سارة وسليم” أمام جمهور كبير وجعل الشباب في تطوان يطرحون سؤال اللغة في السينما. ما معنى أن تحضر العبرية بكل هذه الكثافة في فيلم فلسطيني؟ لحسن الحظ لم يتسرّع أحد ليتَّهِم الفيلمَ وصاحبَه بالتطبيع. ربما صرنا بالتدريج نستوعب الخصوصيتين معًا: خصوصية السينما وخصوصية الحياة المعقّدة للفلسطينيين داخل فلسطين التاريخية وحتى في مناطق السلطة. فلسطين تحتاج منا المزيد من الإنصات والمزيد من التلقّي المُتضامن النّبيه لإنتاجها الأدبي والفني، وتطوان تحتاج منا المزيد من الدعم ليتواصل مهرجانها المتوسطي واحدا من أرقى مهرجانات هذا البلد وأكثرها إخلاصا للسينما فنًّا وقضايا ورهانات.