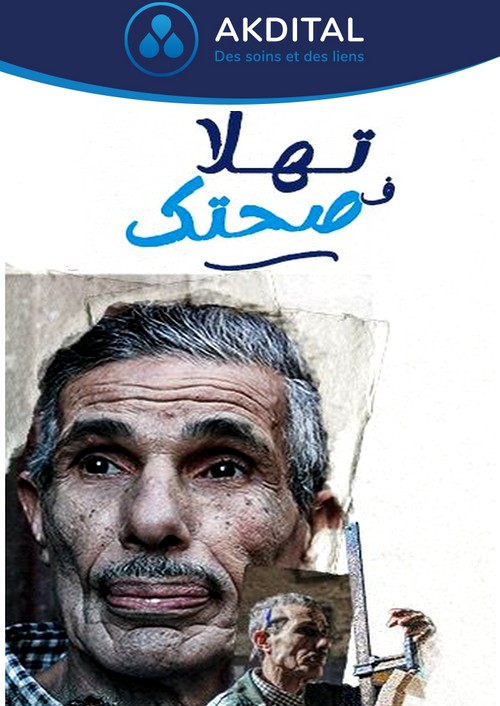كنال تطوان / بقلم : د.يوسف الحزيمري
ـ لولا الأصم والأعرج لما فهمت بلاغة القرآن ـ
إضاءة:
“لا تظن العاهات تمنعك من بلوغ الغايات، فكم من فاضل حاز المجد وهو أعمى أو أصم أو أشل أو أعرج، فالمسألة مسألة همم لا أجسام”.
وقفت على هذا الكلام في كتاب “حتى تكون أسعد الناس” لعائض بن عبد الله القرني، وهو يضم أروع ما قيل من الكلام الحكيم، الذي يتضمن شحنات لتنمية الذات وتطويرها والرفع من هممها، فانقدح في ذهني حديث الإنصات يوم الجمعة ونحن نسمع (روى إمامنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الحديث)، فقلت: هذا أعرج يروي عن الصحابي أبي هريرة رضي الله عنه الذي جمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد المكثرين من الصحابة، فمن هو هذا الأعرج الذي يتكرر على مسامعنا كل جمعة؟ ولَـمْ نكلف أنفسنا بالبحث عنه، هل كان أعرجا حقا؟.
فكان أن بحثنا عن ترجمته فإذا هو: أبو داود عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ هُرْمُزَ عُرف بالأَعْرَجِ، مدني تابعي جليل، أخذ القراءة عرضاً عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم، وكان صاحب قرآن وحديث، ومن أعلم أهل المدينة بالقراءة، وهو أحد أئمة القراءة بالمدينة، قرأ عليه نافع القارئ، وكان ثقة مأمونا حجة فيما نقل، وأول من وضع العربية، قيل: أخذها عن أبي الأسود الدؤلي، وأعلم الناس بأنساب قريش، تحول في آخر عمره إلى ثغر الإسكندرية مرابطا فتوفى في سنة سبع عشرة ومائة[1].
فوجدنا أن “الأعرج” هو لقب له وليس عاهة كما ظننا، لكن ظل السؤال يتردد: ألم يكن ذوو العاهات لهم إسهام في العلم والمعرفة؟، وظل البحث يستفزنا، فكان أن وقفنا على حقيقة ينبغي علينا الوقوف عندها طويلا، وهي أن ذوي العاهات في تاريخنا وحضارتنا الإسلامية كان عليهم مدار العلوم والمعارف، ولم يكونوا أقل شأنا ممن كتب الله لهم المعافاة في الأجسام، ولم تمنعهم العاهة عن أن يتصدروا طبقات الحفاظ والثقاة من الحديث والقراءات والفقه واللغة وغيرها من العلوم الإسلامية…، بل كانوا مدار الإسناد في الرواية والدراية، وبالفعل كانوا ذوي قدرات خاصة احتاج إليهمُ الناس، ولم يكونوا ذوي احتياجات خاصة عالة على المجتمع كما نسميهم نحن اليوم.
ولمن أراد أن يتأكد من هذه الحقيقة فما عليه إلا بالبحث والنظر في فهارس كتب التراجم عامة، وإذا أراد الوقوف عليها بدون تعب فما عليه إلا بكتاب “نكث الهميان في نكت العميان” للصفدي صلاح الدين خليل بن أيبك (تـ764هـ)، فقد ذكر في مقدمته من سبقه في التأليف في الموضوع حيث قال: (وبعد فإني لما وقفت على كتاب “المعارف” لابن قتيبة رحمه الله تعالى. وجدته قد ساق في آخره فصلاً في المكافيف. فعدّ فيهم [جماعة] …ثم رأيت الحافظ جمال الدين أبا الفرج عبد الرحمن بن عليّ بن الجوزيّ رحمه الله تعالى قد ساق فصلاً في آخر كتابه “تلقيح فهوم أهل الأثر” في تسمية العميان الأشراف، ورأيت أبا العباس أحمد بن علي بن بانة قد ذكر في كتابه “رأس مال النديم” أشراف العميان، هذا جملة من رأيته قد ذكره في كتابه، …وأرى أن السابق لذلك ابن قتيبة، ثم بعده هذا ابن بانة، ثم ابن الجوزيّ. وللخطيب أبي بكر خطيب بغداد، جزء جمعه في العميان ولم أره إلى الآن.
وجرى يوماً في بعض اجتماعاتي بجماعة من الأفاضل ذكر فصل استطردت بذكره في شرح لامية العجم. ذكرت فيه جماعة من أشراف العميان، قال لي بعض من كان حاضراً: لو أفردت للعميان تصنيفاً تخصّهم فيه بالذكر، لكان ذلك حسناً.
فحداني ذلك الكلام، وهزّت عطفي نشوة هذه المدام، على أن عزمت على جمع هذه الأوراق، في ذكر من أمكن ذكره أو وقع إليّ خبره وسميته: “نكت الهميان في نكت العميان”).
وكما هزت نشوة المدام مؤرخنا وأديبنا الصفدي، هزتني بدوري أيضا تلك النشوة، فأردت أن أشرك القارئ الكريم في الإحساس بتلكمُ النّشوات، كيما تتغير مشاعرنا نحو ذوي العاهات، وأن ننظر إليهم على أنهم ذوي قدرات، فإن كان الله عز وجل أذهب أبصارهم فقد نور بصائرهم، وإن كتب عليهم أن يكونوا مقعدين فقد خلد ذكرهم في العالمين، ورفع عنهم الحرج في كتابه المبين.
وقفات مع ذوي القدرات الخاصة في تراثنا العلمي:
ونقف هنا مع ذوي القدرات الخاصة الصحابي الجليل أبو أحمد بن جحش الأسدي أخو أم المؤمنين زينب رضي الله عنها، وكان من السابقين الأولين وأول من قدم المدينة من المهاجرين بعد أبي سلمة عامر بن ربيعة وعبد الله بن جحش احتمل بأهله وأخيه عبد الله وكان أبو أحمد ضريرا يطوف بمكة أعلاها وأسفلها بغير قائد وكانت عنده الفارعة بنت أبي سفيان بن حرب وشهد بدرا والمشاهد وكان يدور مكة بغير قائد وفي ذلك يقول:
حبذا مكة من وادي … بها أهلي وعوادي
بها ترسخ أوتادي … بها أمشي بلا هادي[2]
وهذا الصحابي ابن أم مكتوم عبد الله بن قيس بن زائدة بن الأصم بن رواحة القرشي العامري. من السابقين المهاجرين، وكان ضريرا مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع بلال، وسعد القرظ، وأبي محذورة، قال الشعبي: استخلف النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم يؤم الناس، وكان ضريرا وذلك في غزوة تبوك[3].
ونأتي لعصر التابعين فنجد أحد الفقهاء السبعة بالمدينة النبوية، وهو أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، الإمام ، أبو عبد الرحمن، كان ضريرا. وحدث عن عائشة، وأم سلمة، وأبي هريرة، وعنه الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، كان ثقة، فقيها، عالما سخيا، كثير الحديث. قال ابن سعد: ولد في خلافة عمر، وكان يقال له: راهب قريش لكثرة صلاته، وكان مكفوفا. وقال ابن خراش: هو أحد أئمه المسلمين، هو وإخوته يضرب بهم المثل[4].
وهذا تلميذ الإمام مالك، العلامة الفقيه، مفتي المدينة ابن الماجشون، أبو مروان، عبد الملك بن الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة بن الماجشون التيمي مولاهم المدني المالكي، قال مصعب بن عبد الله: كان مفتي أهل المدينة في زمانه. وقال ابن عبد البر: كان فقيها فصيحا، دارت عليه الفتيا في زمانه، وعلى أبيه قبله، وكان ضريرا.[5]
وهذا المحدث الراوية حماد بن زيد (تـ 179 هـ)، البصري، أبو إسماعيل: شيخ العراق في عصره.من حفاظ الحديث المجودين.يعرف بالأزرق.أصله من سبي سجستان، ومولده ووفاته في البصرة. وكان ضريرا طرأ عليه العمى، يحفظ أربعة آلاف حديث.خرج حديثه الأئمة الستة.[6]
و نجد المحدث الكبير أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي السلمي، إماماً حافظاً له تصانيف حسنة، منها: الجامع الكبير في الحديث، وهوأحسن الكتب، وكان ضريراً.[7]
وهذا حفص القارئ (تـ 246 هـ) بن عمر بن عبد العزيز الأزدي الدوري، أبو عمر: إمام القراءة في عصره.كان ثقة ثبتا ضابطا، له كتاب (ما اتفقت ألفاظه ومعانيه من القرآن)، و(قراءات النبي صلى الله عليه وسلم)، و(أجزاء القران)، وهو أول من جمع القراءات وكان ضريرا.[8]
ومن هنا تظهر ريادة ذوي العاهات في تسنم المقامات العالية في تلقي العلوم، وتلقينها، فعليهم كان مدار الرواية في الحديث والفقه واللغة…وغيرها حتى علوم الطب والحساب، وإن مما يدهشنا حقا أنه هؤلاء تنقلوا من أجل ذلك بين المسافات البعيدة جدا من المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى المشرق، كان هذا في ذلك الزمان حيث القفار والصحاري ولا طرق معبدة، ولا وسائل نقل سريعة ومريحة، ولا حتى ما يسمى في عصرنا اليوم بالولوجيات.
فهذا إمام المالكية القابسي ينتقل من إفريقية إلى مصر فمكة مع كونه ضريرا، وهو الحافظ المحدث الفقيه الإمام علامة المغرب، أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري الفروي، أخذ بأفريقية عن ابن مسرور الدباغ ودارس بن إسماعيل، وبمصر عن حمزة بن محمد الحافظ وأبي زيد المروزي وهذه الطبقة، ولد سنة أربع وعشرين وثلاثمائة وكان حافظًا للحديث والعلل بصيرًا بالرجال عارفًا بالأصلين رأسًا في الفقه وكان ضريرًا وكتبه في نهاية الصحة، كان يضبطها له ثقات أصحابه، والذي ضبط له الصحيح بمكة على أبي زيد صاحبه أبو محمد الأصيلي.[9]
وهذا المراكشي محمد بن إبراهيم بن يوسف بن حامد تاج الدين(تـ752هـ)، قال قاضي القضاة تاج الدين بن السبكي في طبقاته الشافعية : كان فقيهاً نحوياً متفنناً مواظباً على طلب العلم جميع نهاره وغالب ليله، يستفرع فيه قواه، ويدع من أجله طعامه وشرابه. وكان ضريراً فلا يفتر عن الطلب إلا إذا لم يجد من يطالع له. مولده بعد السبعمائة. دخل دمشق ودَرس بالمسرورية ثم تركها للشيخ تقيّ الدين السبكيّ. ومن شعره :
** قلة الحظ يا فتى ** صيرتني مجهَّلاَ **
** وجهولٍ بحظه ** صار في الناس أكمَلا** [10]
وفي اللغة ينبغ لغوي الأندلس ابن سيده (تـ 458 هـ) علي بن إسماعيل، ، أبو الحسن: كان إماما في اللغة وآدابها.ولد بمرسية (في شرق الأندلس) وانتقل إلى دانية فتوفي بها. كان ضريرا (وكذلك أبوه) واشتغل بنظم الشعر مدة، وانقطع للأمير أبي الجيش مجاهد العامري، ونبغ في آداب اللغة ومفرداتها، فصنف “المخصص” سبعة عشر جزءا، وهو من أثمن كنوز العربية، و “المحكم والمحيط الاعظم” أربعة مجلدات منه، و “شرح ما أشكل من شعر المتنبي” و “الأنيق” في شرح حماسة أبي تمام، ست مجلدات، وغير ذلك”[11].
وهذا لغوي آخر وهو الأنباري (تـ590هـ) سلامة بن عبد الباقي بن سلامة، أبو الخير، أديب، عالم بالقراآت، من أهل الانبار.سكن مصر، ومات بها. وكان ضريرا. له (شرح مقامات الحريري).[12]
وهذا ضرير آخر شهرته طفقت الآفاق وهو من أهل الأندلس كان إماما في القراءات وهو الشاطبي (تـ 590هـ) القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الرعيني، أبو محمد الشاطبي: إمام القراء.كان ضريرا. وهو صاحب متن الشاطبية المشهور.[13]
ومن العجيب أن نجد شيخ الطريقة الشاذلية أبو الحسن الشاذلى ضريرا (تـ 656 هـ) وشهرته تغني عن تعريفه، فقد ولد في بلاد ” غمارة ” بريف المغرب، ونشأ في بني زرويل (قرب شفشاون) وتفقه وتصوف بتونس، وسكن “شاذلة ” قرب تونس، فنسب إليها. وطلب “الكيمياء ” في ابتداء أمره، ثم تركها، ورحل إلى بلاد المشرق فحج ودخل بالعرق.ثم سكن الاسكندرية. وتوفي بصحراء عيذاب في طريقه إلى الحج.[14]
ومن الشعراء نجد علي بن عبد الغني الفهري الحصري الضرير أبو الحسن، شاعر مشهور كان ضريراً من أهل القيروان انتقل إلى الأندلس ومات في طنجة حفظ القرآن بالروايات وتعلم العربية على شيوخ عصره. اتصل ببعض الملوك ومدح المعتمد بن عباد بقصائد، وألف له كتاب المستحسن من الأشعار.
وقد ذاعت شهرته كشاعر فحل، شغل الناس بشعره، ولفت أنظار طلاب العلم فتجمعوا حوله، وتتلمذوا عليه ونشروا أدبه في الأندلس. له ديوان شعر بقي بعضه مخطوطاً و(اقتراح القريح واجتراح الجريح) مرتب على حروف المعجم في رثاء ولد له، و(معشرات الحصري) في الغزل و(النسيب على الحروف والقصيدة الحصرية) 212 بيتاً في القراءت.[15]
وبعيدا عن الحديث والفقه والتصوف واللغة، نجد ذوي القدرات الخاصة يخوضون مجال علوم نعتبرها اليوم خاصة بالمكتملين عقلا وجسما، فهذا داود بن عمر الانطاكي (تـ1008هـ): نجده مع علمه بالطب والأدب.كان ضريرا، انتهت إليه رياسة الأطباء في زمانه.ولد في انطاكية، وحفظ القرآن، وقرأ المنطق والرياضيات وشيئا من الطبيعيات، ودرس اللغة اليونانية فأحكمها.وهاجر إلى القاهرة، فأقام مدة اشتهر بها، ورحل إلى مكة فأقام سنة توفي في آخرها.كان قوي البديهة يسأل عن الشئ من الفنون فيملي على السائل الكراسة والكراستين، قال المحبي: وقد شاهدت رجلا سأله عن حقيقة النفس الإنسانية فأملى عليه رسالة عظيمة.من تصانيفه (تذكرة أولي الالباب).[16]
وهذا ضرير آخر بارع في الحساب وهو أبو زكريا يحيى بن محمد الضرير البصري، قال عنه القاضي أبي عبد الله حسين بن علي الصيمري: “كان حافظا لمذاهب أصحابنا عارفا بالأصول والجامعين والنوادر مع ورع صيانة وعفاف وتواضع وكان ضريرا، قد رحلت إليه وقرأت عليه وكان عالما بالفرائض قيما بالحساب والجبر والمقابلة إماما في ذلك”[17].
لولا الأصم والأعرج لما فهمت بلاغة القرآن:
وقفت على مقال حول: “سيبويه في ذكراه 1200″، بمجلة دعوة الحق المغربية، العدد: 196، وساق فيها شعرا لجار الله الزمخشري عن كتاب سيبويه ثم قال: “وتلك شهادة من الأعرج الذي لولاه كيوسف السكاكي الأصم لذهبت بلاغة القرءان”.
فرجعت إلى ترجمة يوسف السكاكي صاحب “مفتاح العلوم” في كتب التراجم ولم أقف على إشارة إلى صممه، وهو: يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي أبو يعقوب السكاكي سراج الدين الخوارزمي، إمام في النحو والتصريف والمعاني والبيان والاستدلال والعروض والشعر ، وله النصيب الوافر في علم الكلام وسائر الفنون، ومن رأى مصنفه علم تبحره ونبله وفضله . مات بخوارزم سنة ست وعشرين وستمائة، وذكر غيره أنه ولد سنة خمس وخمسين وخمسمائة.[18]
ولقب بـ «السكاكي» نسبة إلى مهنة السِّكاكة (الحدادة) التي كانت تحترفها أسرته، إذ كانت تشتهر بصناعة السكك (المحاريث)، ووقفت على مادة “سكك” بلسان العرب فإذا هي تعني: “الصمم وقيل السكك صغر الأذن ولزوقها بالرأس وقلة إشرافها وقيل قصرها ولصوقها بالخششاء وقيل هو صغر فوق الأذن وضيق الصماخ وقد وصف به الصمم يكون ذلك في الآدميين وغيرهم”.[19]
أما جار الله الزمخشري فقد كان أعرجا، وكان واسع العلم كثير الفضل غاية في الذكاء وجودة القريحة متفننا يقال كل علم معتزليا قويا في مذهبه مجاهرا به حنفيا. ولد في رجب سنة سبع وستين وأربعمائة وورد بغداد غير مرة وأخذ الأدب عن أبي الحسن عليّ بن المظفر النيسابوري وأبي مضر الأصبهاني وسمع من أبي سعد الشقاني وشيخ الإسلام أبي منصور الحارثي وجماعة وجاور بمكة وتلقب بجار الله وفخر خوارزم أيضاً. وكتب إليه الحافظ السلفي يستجيزه وأصابه خراج في رجله فقطعها وصنع عوضا عنها رجلاً من خشب وكان إذا مشى ألقى عليها ثيابا طوال فيظن من يراه أنَّه أعرج.
و له من التصانيف : “الكشاف” في التفسير “الفائق” في غريب الحديث “المفصل” في النحو “المقامات” “المستقضي في الأمثال” وغير ذلك مات يوم عرفة سنة ثمان وثلاثين وخمس مائة.[20]
خاتمة:
فهذا غيض من فيض في الدلالة على أن ذوي العاهات أو ذوي الاحتياجات الخاصة كما نسميهم نحن اليوم، إنما هم ذوي قدرات خاصة، فهذا هو الاسم الأليق بهم، وإن مجتمعنا اليوم لفي حاجة إليهم أشد الاحتياج.
الهوامش:
- طبقات النسابين (ص: 4) نزهة الألباب في الألقاب (1/ 82) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (2/ 337) تذكرة الحفاظ للذهبي (1/ 75)
- الإصابة في تمييز الصحابة (7/ 6)
- سير أعلام النبلاء (1/ 361)]
- سير أعلام النبلاء (4/ 417- 416)
- سير أعلام النبلاء (10/ 358)
- الأعلام للزركلي (2/ 271).
- الكامل في التاريخ (3/ 345)
- الأعلام للزركلي (2/ 264)
- تذكرة الحفاظ وذيوله (3/ 186)
- بغية الوعاة (1/ 16)
- الأعلام للزركلي (4/ 263)
- الأعلام للزركلي (3/ 107)
- الأعلام للزركلي (5/ 180)
- الأعلام للزركلي (4/ 305)
- تراجم شعراء الموسوعة الشعرية (ص: 1734)
- الأعلام للزركلي (2/ 333)
- أخبار أبي حنيفة (ص: 173)
- بغية الوعاة (2/ 364)
- لسان العرب (10/ 439)
- أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض (ص: 333)